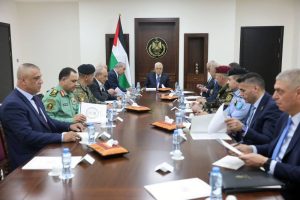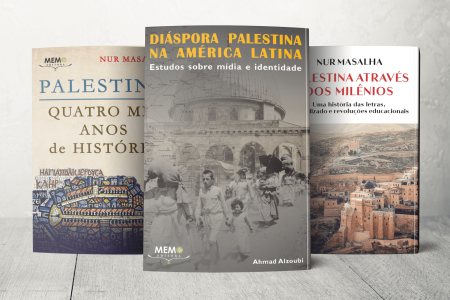وأوضح صاحب (الإسلام والعنف) أن الإسلام من خلال راديكالية بعض أتباعه غدا عبئاً أمنياً على العالم الليبرالي ومشاريع الهيمنة الجديدة بمعزل عن الوجه الثقافيّ الطليعيّ الذي مثّلته نخبٌ ثقافية غربية كشفت، وبصورةٍ نقدية – تفكيكية، عن المركزية الغربية وعن إرادة الهيمنة التي تقودها من خلال ذلك النقد الوجيه الذي نزع النقاب عن النسبية الثقافية.
ويرى أدونيس أن همّ الإسلام الحركي اعتقال التاريخ، وتكبيل التقدم، وطمس الذاتية، وإلغاء بُعد المجهول في الذات والعالم؛ ما يوجب تحرير العالم والوجود من هيمنة النص المُؤسِّس وعِتق المعرفة من المُسبَّق، لافتاً إلى أن الرؤية الدينية القائمة على عنفٍ بنيوي لا يُمكنُ أن تتأسَّس عليها الحياة المدنية الحديثة أو احترام حقوق الإنسان، بحكم انعزال مؤسَّساته الرسمية عن قيم الأنوار والأنسنة التي كانت في أساس مشروع الحداثة الضخم.
وحمّل أدونيس الوحدانية المسؤولية باعتبارها مُؤسَّسة تاريخية وثقافية؛ همها الأكبر القضاء على التعدد الثقافي في الفضاء المُتوسطي وخنق ثقافة السؤال ومُغامرات العقل.
ويذهب إلى أن كل رؤية شمولية تحمل جرثومة الاستبداد والأحادية التي تستبعد المُختلف وتقمع المُغايرة وتطمسُ التعدد، وحينها لا يُمكن للرؤية الشمولية المغلقة أن تحفل باحترام الآخر المُختلف ثقافياً أو بالديموقراطية سياسياً إلا من خلال «خرق ثقافي» ونقد جذري لها. وعدّ الموقفَ الإسلاميَّ التقليدي الناهل من الرؤية الإسلامية النهائية للعالم والأشياء دعوة واضحة إلى العنف الذي يطرح مشكلاتٍ خطيرة على العالم اليوم، مشيراً إلى أن فهم حاضر الإسلام يحتاج النظر إليه باعتباره تاريخاً ومُؤسَّسة وسلطة، وبرزت فيه بصورةٍ جلية البنية القبلية وشهوة الهيمنة والمال مع ما رافق ذلك من مُمارسات عنفية كان أبرزها إقصاء الآخر وقتل المُعارضين ومُطاردة الفكر المُختلف، وتمثل الفعل العنفي في أساس المُجتمع الإسلامي الأول والدولة الإسلامية الأولى، التي عززت فكرة الحبل والولادة بالواحدية والتكرار؛ المتمحورة حول السلطة السياسية التي تفرضُ قراءتها الخاصة للنص المُقدَّس بما يخدمها ويُبرِّرُ توجهاتها وأفعالها.
وذهب إلى أن منشأ الإسلام لم يخلُ من (الجينيالوجيا) التاريخية التي تربطه بسياقاتٍ حضارية واقتصادية وسياسية جعلت منه نتاجاً للصِّراع على النفوذ القبلي في الجزيرة العربية أولاً وحوض المتوسط لاحقاً. وكانت التجارة عاملاً مهماً في ذلك كما كان هاجسُ السلطة مركزياً. فولدت الوحدانية الإسلامية، باعتبارها تأسيساً للواحدية على الأرض وكانت، بذلك، تأسيساً لعالم أمبرياليّ خالٍ من التعدد الثقافي والفكري والسياسيّ. ظلت الوحدانية إيديولوجية للإمبراطورية الناشئة واغتصاباً لفسيفساء العالم الثقافية، مضيفاً بأن الأمر لا يتعلق بالإسلام فحسب، وإنما بكل منظومةٍ أيديولوجية شمولية لا مكان فيها للمُختلف.
وتساءل (عرّاب الحداثة العربية): هل خرج العنفُ الذي يُمارَسُ باسم الإسلام اليوم من النصوص التأسيسيَّة لهذا الدين أم من الواقع الذي يعيشه المُسلمون؟ من الرؤية التي كرَّسها الإسلام للوجود والعالم والمرأة والآخر؟ أم من تراجيدياً التاريخ البائس الذي جعل من المُسلمين ضحايا يبحثون عن خلاصهم في التشبث بالهوية والتطهر من العالم، مؤكداً أن الاعتماد على النصوص التأسيسية لثقافةٍ ما قد لا يُساعدنا كثيراً على فهم حاضرها المُعقد أو فهم علاقاتها المُلتبسة مع الآخر، فالنصوص لا تنتجُ التاريخ ولا يُمكن اعتبارها أسباباً أولى – بالمعنى الفلسفي الميتافيزيقي – تتحكمُ بخيوط الفوضى الكونية التي يُهيمن عليها العنف باسم الدين اليوم، كونها ذاتها نتاجاً للتاريخ ولبنياتٍ أنثروبولوجية عميقة حدَّدت مصائرَ العلاقات بين البشر ومُجمل الرموز التي ستشكل الحكايات التأسيسية لتجربة البشر في الوجود، مرجحاً أن الإرهاب اليوم لا يستندُ إلى مرجعية القرآن بمعزل عن التاريخ الفعليِّ للمسلمين الذين ظلوا عرضة للاضطهاد والاستعمار الغربي من جهةٍ، وضحايا لاستبداد وفساد الدولة العربية الوطنية من جهةٍ أخرى.