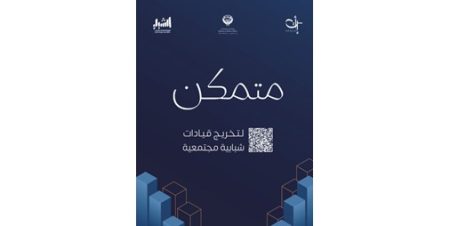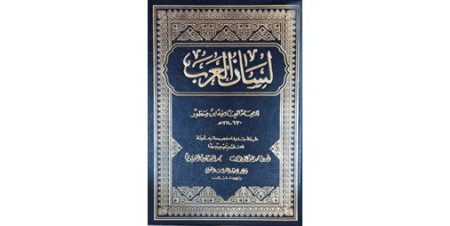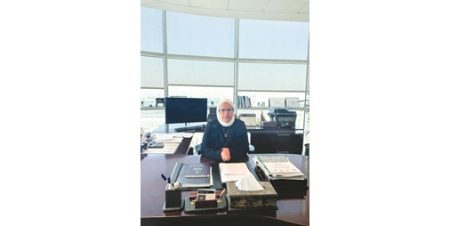بقلم: د. يعقوب يوسف الغنيم
في مطلع سبعينيات القرن الماضي اتجهت في رحلة سياحية إلى مدينة تطوان المغربية، وهي مدينة كنت أتمنى أن أراها منذ كنت تلميذا صغيرا في المدرسة الأحمدية في بلادي الكويت.
وكان ذلك مستحيلا في الوقت الذي علمونا فيه نشيدا مطلعه:
بلاد العرب أوطاني
من الشام لبغدان
ومن نجد إلى يمن
إلى مصر فتطوان
وكنا نردد هذا النشيد في أوائل أربعينيات القرن المشار إليه قبل قليل، وكان وقتا يستحيل فيه السفر إلى ذلك المكان البعيد بسبب صعوبة المواصلات، ولذا فإنني لم أتمكن من تحقيق رغبتي تلك إلا بعد زمن طويل، فقد كانت الظروف تملي علينا أحكامها.
وصلت إلى تطوان قادما من إشبيلية الأندلسية (وهي في إسبانيا الآن) وبعد زمن قصير من إقلاع الطائرة، بدأت خطواتي الأولى في تلك البلدة الرائعة فور وصولي إليها.
أمضيت يومين في تطوان، ثم غادرتها بسيارة من سيارات الأجرة إلى طنجة القريبة منها.
وطنجة مدينة مغربية قديمة تقع على ساحل البحر وصفها ابن حوقل في كتابه: «المسالك والممالك» فقال: «طنجة مدينة أزلية، آثارها ظاهرة، بناؤها بالحجارة، قائمة على البحر، والمدينة العامرة الآن على ميل من البحر (وذلك في زمنه)، وليس لها سور، وهي على ظهر جبل. وماؤها في قناة، وقد ذكر فيها عددا من العلماء».
ورد هذا في كتابه صورة الأرض الذي ألفه في سنة 977م.
تم فتح طنجة على يد البطل المسلم موسى بن نصير، في سنة 701م، وبعد أن تم له ذلك، أقر عليها طارق بن زياد، وبعد فترة قصيرة من الزمن أمره بالاتجاه إلى الأندلس وفتحها، فكان له ما أراد.
وكان المدخل إلى تلك البلاد هو جبل طارق الذي أُطلق عليه فيما بعد الفتح اسم هذا البطل الفاتح، كما أطلق اسمه أيضا على الممر البحري المحاذي له.
ومنذ الفتح ومدينة طنجة على كل لسان، وكان الناس بعد ذلك يمرون بها في طريقهم عند الذهاب أو الإياب فيما بين الأندلس والديار المغربية.
وطنجة – باختصار – مركز مهم في أقصى شمالي المملكة المغربية عند ملتقى البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي.
موقعها استراتيجي، وهي بوابة تؤدي من أفريقيا إلى أوروبا، وتشتهر باحتوائها على ثقافات مختلفة تتمثل في كثير من المظاهر والمعالم التاريخية المهمة.
وكانت طنجة تحت إدارة دولية، ولم تعد إلى مسؤولية الإدارة المغربية إلا في سنة 1956م.
استمتعت – كثيرا – بكل ما شاهدته في هذا البلد الجميل، وسرت في طرقاته التي تدل على ماضيه، كما شاهدت الأسواق التي كانت مكتظة بأنواع البضائع، وعلى الأخص منها تلك المصنوعات اليدوية ذات الإتقان، والدلالة على مقدرة صانعيها، فهم مختصون بهذا ومشهورون به.
وكانت من محطات جلوسي هناك مقهى من المقاهي التي كانت تنتشر على الساحل، وكان أمام هذا المقهى ممر بحري يشبه جون الكويت تماما، وكان أمامي حين جلست – فيما وراء البحر – الجبل المعروف باسم جبل طارق الذي جاء ذكره في التاريخ الإسلامي، واحتفظ باسمه إلى يومنا هذا منذ افتتاح الأندلس على يد القائد المسلم طارق بن زياد في سنة 711م، وكان قد سار بجيشه عبر المضيق المسمى هو والجبل باسم هذا الفاتح. وكان قد قام بعمله هذا بأمر من والي افريقيا – آنذاك – موسى بن نصير، وهو واحد من ولاة الدولة الأموية. وبالتحديد في زمن حكم الخليفة الأموي، الذي توفي سنة 705م، عبدالملك بن مروان.
جلست متأملا، ومتذكرا لحركة التاريخ في هذا الموقع معجبا بسرعة انتشار الإسلام، ووصول أبنائه إلى هذا المكان النائي عن موطنهم الأصيل في جزيرة العرب.
ولقد كان أول الفتوح قريبا من هذه الجزيرة، وقد تم في سنة 633م ولم تأت سنة 711م إلا وقد اجتازت الجيوش الإسلامية كثيرا من البقاع حتى وصلت إلى الأندلس، ونحن عندما نلقي نظرة على خريطة البلدان الإسلامية، فإننا نعجب أن تصل المساحة التي غطاها الإسلام بالاتساع الذي نراه، وهذا أمر يثير العجب لأن هذا تم في مدى ثمان وسبعين سنة. ولا شك في أن لما حدث دلالات كثيرة يعرفها من يتأمل.
في هذا الموقع المثير للذكريات جلست أستخبر التاريخ، وأتأمل المكان الذي شهد أهم الأحداث، فطنجة بلدة ذات طابع تاريخي عريق، مبانيها تشبه المباني الأندلسية التاريخية وهي الآن قريبة من تطوان المسجلة ضمن قائمة التراث العالمي في سجلات منظمة اليونسكو منذ سنة 1997م.
تقع في شمال المملكة المغربية على البحر الأبيض المتوسط، وهي موقع سياحي مهم يأتيها السياح من كل مكان.
٭ ٭ ٭
بينما كنت في موقعي ذاك جالسا أمام البحر الذي تطل عليه مدينة طنجة من جهة، وجبل طارق ومضيقه من جهة أخرى خطر ببالي أمر مهم جرى في التاريخ الإسلامي، وكان هذا على التحديد زمن سقوط الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية، وذلك في سنة 132هـ (750م)، وذلك لأن هذا الموقع الذي أراه على الساحل المقابل عبر الممر البحري الذي ذكرته كان موضع حدث آخر مهم جدا، وهو ما قام به الأموي عبدالرحمن الداخل الملقب بـ «صقر قريش» عندما اخترق الآفاق فارا من تلك الحرب التي شنها العباسيون على الدولة الأموية وأقاموا بناء على نتائجها دولتهم، مما جعله يتجه إلى أبعد نقطة في بلاد الإسلام آنذاك فيصل إلى الأندلس مارا بمضيق وجبل طارق لكي يقيم الدولة الأموية البديلة هناك.
وصقر قريش هو عبدالرحمن بن معاوية الأموي، وهو الذي يُطلق عليه – أيضا – اسم عبدالرحمن الداخل. كان شابا حدث السن حين وقعت عليه الحرب موقعا سيئا وصفه بقوله: «لما أعطينا الأمان ثم نكث بنا على نهر أبي فطرس، وأبيحت دماؤنا، أتانا الخبر. وكنت منتبذا من الناس، فرجعت إلى منزلي آيسا، ونظرت فيما يصلحني وأهلي وخرجت خائفا، حتى صرت في قرية على الفرات ذات شجر وغياض، فبينما أنا ذات يوم بها وولدي سليمان يلعب بين يدي وهو يومذاك ابن أربع سنين، فخرج عني، ثم دخل الصبي من باب البيت باكيا فزعا، وجعلت أدفعه وهو يتعلق بي. فخرجت لأنظر، إذا بالخوف قد نزل بالقرية، وإذا بالرايات السود منحطة عليها، وأخ لي حديث السن يقول لي: النجاة النجاة فهذه رايات المسودة. فأخذت دنانير معي ونجوت وأخي، وأعلمت أخواتي بمتوجهي، فأمرتهن أن يلحقني مولاي بدرا. وأحاطت الخيل بالقرية فلم يجدوا لي أثرا، فأتيت رجلا من معارفي، وأمرته فاشترى لي دواب وما يصلحني. فدل علي عبدالله العامل، فأقبل في خيل له يطلبني، فخرجنا على أرجلنا هرابا والخيل تبصرنا، فدخلنا في بساتين على الفرات، فسبقنا الخيل على الفرات فسبحنا. فأما أنا فنجوت والخيل ينادوننا بالأمان ولا أرجع. وأما أخي فإنه عجز عن السباحة في نصف الفرات، فرجع إليهم بالأمان وأخذوه فقتلوه وأنا أنظر إليه، وهو ابن ثلاث عشرة سنة. فاحتملت فيه ثكلا ومضيت لوجهي، فتواريت في غيضة أشبة حتى انقطع الطلب عني، وخرجت فقصدت المغرب حتى بلغت أفريقيا».
(عن كتاب: «زعماء الإسلام للدكتور حسن إبراهيم حسن) وقد وصف مؤلف الكتاب المذكور هنا هذا البطل بقوله:
«كان عبدالرحمن ينظر في المظالم بنفسه وينصف الضعيف من القوي. فكان إذا حل وقت الطعام دعا إلى مائدته أصحابه ومن قصده من أصحاب الحاجات. وقد حكم بلاد الأندلس ثلاثا وثلاثين سنة وأربعة أشهر، ومات سنة 172هـ، وعاصر من الخلفاء العباسيين المهدي والمنصور والرشيد، وأدرك الغرض الذي سعى إليه وهو في ميعة الصبا وريعان الشباب، وأخضع العرب والبربر، وعدل بين الناس فأحبته الرعية، وبعث ملك بنى أمية. وما أحسن ما وصفه به أبو حيان حين قال عنه: «كان عبدالرحمن راجح الحلم، واسع العلم، ثاقب الفهم، كثير الحزم، نافذ العزم، بريئا من العجز، سريع النهضة، متصل الحركة، لا يخلد إلى راحة، ولا يسكن إلى دعة، ولا يكل الأمور إلى غيره، ثم لا ينفرد في إبرامها برأيه، شجاعا مقداما، بعيد الغور شديد الحدة، قليل الطمأنينة، بليغا مفوها، شاعرا محسنا، سمحا سخيا، طلق اللسان. وكان يلبس البياض، ويعتمّ به ويؤثره. وكان قد أعطي هيبة من وليه وعدوه. وكان يحضر الجنائز ويصلي عليها، ويصلي بالناس إذا كان حاضرا الجمع والأعياد. ويخطب على المنبر، ويعود المرضى، ويكثر مباشرة الناس والمشي بينهم».
وبعد أن تكبد المزيد من المشاق وصل إلى أفريقيا، وكان يأمل في أن تتاح له الفرصة فيكون أميرا عليها، ولكنه لم يتمكن من تحقيق ذلك. ومن أجل هذا فإن نظره اتجه إلى الأندلس، فبعث إلى زعماء الأمويين فيها، وإلى عدد من أبناء اليمن المقيمين هناك برسول من عنده، وقد عاد هذا الرسول فيما بعد بالبشرى، إذ ذكر له أنهم يرحبون به أميرا عليهم ويدعونه إلى هناك.
ولم يتأخر صقر قريش فركب سفينته إلى هناك مصاحبا بعدد ممن التحق به، وقد بادرت القبائل اليمنية إلى الترحيب به، وإبداء رضاهم بحكمه لهم. ولذا فقد نجح في اقتطاع الأندلس من جسم الدولة العباسية، بل ونكل بالمقيمين هناك من رجالها وقتل منهم عددا كبيرا حتى لقد هال الخليفة العباسي المنصور ما رآه من آثار ذلك العمل.
وفور استتباب الأمر له، بدأ في إقامة الأعمال التي تكفل استمراره في الحكم، فاتخذ من مدينة قرطبة عاصمة لملكه وأنشأ المباني والحدائق، وجلب من الشام أنواعا من الفواكه فغرسها هناك، ومن ذلك أنه غرس النخيل وقال حين وقف أما نخلة من غرسه:
تبدت لنا بين الرصافة نخلة
تناءت بأرض الغرب عن بلد النخل
فقلت: شبيهي في التغرب والنوى
وطول ابتعادي عن بني وعن أهلي
نشأت بأرض أنت فيها غريبة
فمثلك في الإقصاء والمنتأى مثلي
ولقد صارت الأندلس بعد هذه الجهود التي بذلها صقر قريش في الزراعة والبستنة جنة خضراء زاهية، يقول شاعرها إبراهيم بن خفاجة الأندلسي:
يا أهل اندلس لله دركم
ماء وظل وأنهار وأشجار
ما جنة الخلد إلا في دياركم
ولو تخيرت هذي كنت أختار
لا تحسبوا بعد ذا أن تدخلوا سقرا
فليس تدخل بعد الجنة النار
وخلاصة الأمر في شأن الأندلس هو ما ذكره ياقوت الحموي في كتابه «معجم البلدان» ج2 ص264، حين أفرط في الحديث عنها ثم أضاف في آخر ما كتب قوله:
«ولولا خوف الإضجار والإملال، لبسطت القول في هذه الجزيرة، فوصفها كثير، وفضائلها جمة، وفي أهلها أئمة، وعلماء، وزهاد، ولهم خصائص كثيرة، ومحاسن لا تحصى، وإتقان لجميع ما يصنعونه».
٭ ٭ ٭
تغطي الأندلس المساحة التي تشغلها اليوم كل من دولتي إسبانيا والبرتغال. وكان العرب المسلمون قد استقروا بها مدة ثمانية قرون بدأت في سنة 711م، وانتهت في سنة 1492م. وكان آخر ما سقط منها مملكة غرناطة.
ولقد شهدت في الزمن العربي نشاطا ثقافيا وعلميا شديدين، وبرز فيها عدد من العلماء نذكر منهم ابن رشد الذي لايزال يحتفظ بمكانته في إسبانيا نفسها، ومن الشعراء ابن زيدون الذي نال تقدير الأدباء والنقاد، وكانت له قصيدة شهيرة مطلعها:
أضحى التنائي بديلا عن تلاقينا
وناب عن طيب لقيانا تجافينا
وهي التي عارضها أمير الشعراء أحمد شوقي فقال:
يا نائِحَ الطَلحِ أَشباهٌ عَوادينا
نَشجى لِواديكَ أَم نَأسى لِوادينا
ماذا تَقُصُّ عَلَينا غَيرَ أَنَّ يَداً
قَصَّت جَناحَكَ جالَت في حَواشينا
هذا، ويلاحظ المتتبع لأحوال الأندلس تقدما كبيرا في المجال المعماري بكل صوره، فقد بنيت في العهد العربي مدن لم تكن قائمة من قبل، وكانت من أهمها مدينة الزهراء الشهيرة، وغيرها من المباني كالقصور والمساجد والحدائق وغيرها من المظاهر المشابهة.
ولم يكن هذا فقط، بل اشتهرت هذه البلاد بأمور أخرى مثل الموسيقى التي بقيت ألحانها إلى يومنا هذا، ويطلق عليها الآن اسم: موسيقى الفلامنكو. والموشحات، وهي القصائد ذات الوزن العروضي المتميز الذي أتقنه الشعراء هناك، وقد صار الآن مما يغنى على صوره مبهرة تسر السامعين إلى يومنا هذا، وقد اشتهر بهذا النوع من الغناء الفنان السوري صباح فخري، الذي سجل من هذا الفن قصائد كثيرة.
ولمزيد من الحديث عن هذا الموضوع فإن من الجدير بنا أن نذكر أن الأجواء العربية لاتزال تردد هذه الموشحات، ونذكر منها:
جادك الغيث إذا الغيث همى
يا زمان الوصل بالأندلس
لم يكن وصلك إلا حلما
في الكرى أو خلسة المختلس
وأخيرا، فإننا نطلع اليوم في كتب تاريخ الأندلس على ما جرى على أهلها من تشريد، وقتل وإيذاء ومصادرة أملاك، ونرى – أيضا – روايات صدرت في عصرنا الحالي وهي تسجل تلك الأحداث الكئيبة، فقد صدرت للروائية رضوى عاشور رواية ذات قيمة أدبية عالية كتبتها في ثلاثة أجزاء تحت عنوان: «ثلاثية غرناطة» وهي تسجل تلك الفترة الأخيرة من أيام الأندلس العربية بما يثير الحزن على كل ما جرى لها ولأهلها من مآس اجترحها أناس لم يكونوا يدركون القيمة الكبرى لكل ما دمروه مما صوره الشاعر الأندلسي أبو البقاء الرندي المتوفى سنة 798هـ (1396م). وكان مطلعها:
لكل شيء إذا ما تم نقصان
فلا يُغّرَ بطيب العيش إنسان
ومنها قوله:
دهى الجزيرة أمر لا عزاء له
هوى له أُحد وانهدّ ثهلان
أصابها العين في الإسلام فارتزأت
حتى خلت منه أقطار وبلدان
فاسأل بلنسية ما شأن مرسية
وأين شاطبة أم أين جيان
وأين قرطبة دار العلوم فكم
من عالم قد سما فيها له شان
وأين حمص وما تحويه من نزه
ونهرها العذب فياض وملآن
قواعد كنّ أركان البلاد فما
عسى البقاء إذا لم تبق أركان
تبكي الحنيفية البيضاء من أسف
كما بكى لفراق الإلف هيمان
على ديار من الإسلام خالية
قد أقفرت ولها بالكفر عمران
حيث المساجد قد صارت كنائس ما
فيهن إلا نواقيس وصلبان
حتى المحاريب تبكي وهي جامدة
حتى المنابر تبكي وهي عيدان
٭ ٭ ٭
لاتزال الأندلس في نفوسنا نحن المسلمين، نذكر تاريخها ونتتبع آثارها الثقافية الفريدة، ونردد أشعار شعرائها ونفخر بكل ما كان فيها من مظاهر العز والرفعة، ومظاهر التقدم والرقي في كل المجالات. وما زال الكثيرون منا يقومون بزيارتها رغبة في استجلاء ذلك التاريخ المجيد.
ونحن – هنا في الكويت – نذكرها بصورة دائمة، فأنّى التفتنا وجدنا في بلادنا ما يدلنا عليها. فهنا منطقة الأندلس السكنية، ومنطقة قرطبة السكنية، ومنطقة غرناطة السكنية أيضا، وهناك مدارس حكومية كثيرة تحمل أسماء بعض مدن الأندلس ومنها على سبيل المثال مدرسة طليطلة ومدرسة أشبيلية، وهذا بخلاف المدارس الواقعة في المناطق السكنية ذات الأسماء الأندلسية.
ونحن – اليوم – نلاحظ اهتمام إسبانيا – حكومة وشعبا – بالأحداث العربية، ودعمها للمواقف المناهضة لكل ما هو معاكس لمصالح العرب.. وكل هذا يدعونا إلى اتخاذ موقف فيه مقاربة لما يقومون به، وبخاصة وأننا نرى من أفراد الشعب الاسباني حنينا إلى عصر الإسلام في بلادهم وهذا أمر نجده ماثلا في وسائل الاتصال الاجتماعي المعروفة.
٭ ٭ ٭
هنا عود إلى الحديث عن صقر قريش (عبدالرحمن بن معاوية الأموي)، وفي هذه العودة إضافة إلى ما سبق وأن جرى ذكره عن هذا الرجل الذي سجل أعماله التاريخ الإسلامي، وله ارتباط شديد بتاريخ الأندلس.
– أطلق على هذا الرجل اسم عبدالرحمن الداخل، لأنه دخل الأندلس بكل يسر، ولم يلق إلا قليلا من المنغصات التي قضى عليها فاستقر في تلك البلاد بعد ذلك. وكانت تلك المنغصات بسبب تنافس أهل تلك البلاد، ورغبة كل فئة منهم في الاستفادة من النظام الجديد.
– إضافة إلى ذلك فإنه ابتدأ حكمه في منطقة لا تشمل الأندلس كلها لوجود بعض المعارضين في جهات أخرى من تلك البلاد، ولكنه بحسب ما رأينا من همته وإقدامه استطاع أن يقوم بتوسيع منطقة حكمه حتى شملت الأندلس كلها.
– وكان صقر قريش مهتما بكل نواحي التقدم في دولته، ولذا فقد كان من ضمن اهتمامه تشجيع العلم والعلماء، ويكفي للدلالة على ذلك أن المؤرخ شمس الدين ابن خلكان قد ذكر في كتابه «وفيات الأعيان» (ج2 ص218) اسما واحدا من العلماء البارزين، فقال إنه مولى عبدالرحمن بن معاوية (صقر قريش)، وأنه صاحب كتاب «المقتبس في تاريخ الأندلس». كان قد خطه في عشرة مجلدات، وهو مطبوع، وكتاب «المتين» في تاريخها أيضا، وقد خطه في ستين مجلدا.
– وأما اللقب الذي اشتهر به، وهو «صقر قريش» فقد أطلقه عليه واحد من ألد أعدائه، وهو الخليفة العباسي المنصور الذي حارب الأمويين، وحرص على إبادتهم، ولم يقدر على عبدالرحمن الداخل على الصفة التي أوردناها.
وقد ورد أنه قال عنه سأل الجالسين في واحد من مجالسه:
– أتدرون من هو صقر قريش؟
فرد كل واحد منهم ذاكرا اسما من أسماء بني العباس إرضاء له، ولكنه قال:
– صقر قريش هو عبدالرحمن بن معاوية الذي خرج فارا، وحيدا، حتى دخل الأندلس، فأقام بها ملكا متخطيا كل الصعاب التي واجهته.
هذا هو صقر قريش، وقديما قيل: «والفضل ما شهدت به الأعداء».